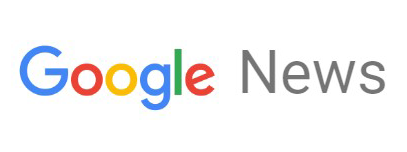التعليم والأدب.. والثقافة!

يخلط كثيرون بين الثقافة من جهة، والتعليم والأدب من جهة أخرى، وهو خلط ممنهج جرى "تصنيعه” على مدار عقود. لكن، وبعيدا عن المفاهيم "الإشكالية” التي انتهجتها اليونسكو لتعريف الثقافة، والتي أدخلتنا، أحيانا، في إبهام حقيقي لا يكشف شيئا، فإن الثقافة بمفهومها البسيط هي أدوات المجتمع التي طورها عبر سيرورته الطويلة لتأمين خطوات تطوره، مع المحافظة على هويته التي يمكن له أن يقدمها للعالم كخصوصية لا تلغي عنه انتماءه إلى الإنسانية الجمعاء، ما يجعله في خانة الدفاع عن خصوصيته، أولا، ثم عن تنوع ينبغي له أن يظل قائما، بغض النظر عن طبيعة المجتمع الذي تنتمي له تلك الخصوصية.
لكن، وفي حسابات لم نستشر فيها، بات تقديم الأدب كثقافة أولوية لدى كثيرين، وفي مزيد من التضليل، بات تقديم الأدب التغريبي في العالم العربي عنوانا وحيدا للثقافة، بينما من يمتلك وجهة نظر مغايرة يتم تصنيفه خارج المنظومة الثقافية، كأن يطلق عليه مصطلح "إحيائي”، أو تقليدي، وفي أحسن الأحوال "توفيقي”.
في كثير من تلك الافتراءات، وخلال العقود القليلة الماضية، وقفت العولمة عاملا مساعدا وحاسما في تبرير الاتهامات التي يطلقها أشخاص غير منسجمين مع ثقافة مجتمعاتهم وهم في صدد إثارة الأسئلة الإشكالية، والتي لا تحاول تقديم إجابات يتم البناء عليها لتطوير المنظومة المجتمعية بقدر ما تحاول إلغاء الخصوصيات لمصلحة ثقافة كونية لا تعترف بالمجتمعات التي تم الاستيلاء على خصوصياتها من خلال نظام عالمي تبنى الاعتراف بالقوة كمحرك وحيد للتعايش والتثاقف؛ القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية.
من خلال تلك المنظومة التي طورها نظام عالمي ظالم عبر عقود، تم إفراد نظام شمولي للثقافة يتأسس على ثقافة المنتصر، أو الاستعمار بمفهومه الكلاسيكي، أو الاستعمار الحديث الذي تعدى الأطر الكلاسيكية نحو فرض أنماط سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية على البيئات الخاضعة، وبما يتوافق مع مصالحه الآنية والمستقبلية، بعيدا عن أي اعتبارات لخصوصية المجتمعات التي باتت تفقد هوياتها المميزة بسبب خضوعها لاشتراطاته، وباتت عاجزة عن الخروج من دوائر تأثيراته.
المشكلة لم تعد في القوى الإمبريالية التي تحاول جاهدة الحفاظ على موقعها كقوى منظمة لحراكية العالم وتقاسم ثرواته، بل في المجتمعات التي استسلمت لدور تلك القوى، واستسلمت أيضا لترتيبها المتخلف على لائحة الحضارة الإنسانية، واعتقدت بعجزها عن تقديم أي أنموذج يمكن أن يشكل خصوصية ما لها، وأن تطوره لأن يكون أنموذجا عالميا.
في الخلط بين الكتابة الأدبية والتعليم، وبين الثقافة، يراد لنا أن نصدق أن ملايين الجامعيين العرب هم نخب مثقفة، وأن مئات آلاف المبدعين هم كذلك، وأن إسهاماتهم في هذا الإطار هي إسهامات لبلورة العملية الثقافية، أو الصبغة التي ينبغي لها أن تسود في المجتمع. والحقيقة المرة أن تلك الإسهامات كرّست التبعية المطلقة للقوى الكبرى، من خلال عدم أصالة النتاجات في معظم ما يطرح في دوائر الأكاديميا، وأيضا في تغريب النتاج الأدبي، واتخاذه، غالبا، صبغة بعيدة عن هموم المجتمعات المحلية وتحدياتها، نحو مفاهيم واهتمامات لم تتبلور بعد كأولويات لدينا.
في كل ذلك الخلط، تقف الثقافة، التي ينبغي لنا بلورتها، خارج أطر التفكير والاهتمام، فالسوق مليئة بالثقافات العديدة التي نتبناها كلما دعت الحاجة، لذلك لا ضرورة لأن نتعب أنفسنا في البحث عن جوهر وجودنا، خصوصا أنه ما من أحد يريد أن يقول لنا إن الثقافة هي أداة رفع وعي المجتمعات، وهي فعل مقاومة لكل ما من شأنه أن يبقينا على خريطة الإنسانية.
الثقافة ليست في زيادة أعداد المتعلمين، رغم أهمية ذلك، ولا هي في النتاجات الأدبية التي تمتلئ بها السوق، بل هي في دراسة خصوصيات المجتمع وتحدياته، وتأطير هوية جامعة له تكون مستندة إلى المفاهيم والإرث الذي طوره، من خلال إعادة دراسته وتقييمه بما يشبه الهدم وإعادة البناء، وأيضا بإيلاء نظرة إلى المستقبل الذي نريده.
الثقافة، في النهاية، هي القدرة على الانخراط في الشأن العام، وبلورة موقف واضح تجاه ما من شأنه أن يقود المجتمع نحو المستقبل، حتى لو أدى ذلك إلى الاصطدام بالسلطة مهما كان شكلها؛ سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، ومن دون ذلك لن يكون هناك أي علاقة بين الفرد والثقافة!