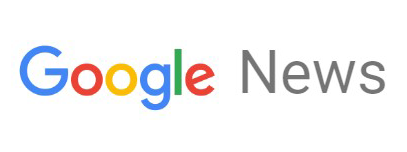مشاعر مفهومة تجاه سورية.. ولكن

مكرم أحمد الطراونة
المشاعر غير المحدودة التي عبر عنها الأردنيون تجاه ما يحدث في سورية، هي تعبيرات حقيقية تجاه جغرافيا جارة وشعب شقيق، ولها ما يبررها في قاموس الأردنيين الذين عاشوا دائما أفراح وأتراح الشعوب العربية في كامل خريطة الوطن العربي المبتلى بالمآسي على مدار أكثر من قرن كامل.
لقد عبر الأردنيون بصدق عن فرحهم لأشقائهم بخلاصهم من واحد من أكثر الأنظمة القائمة قمعية ووحشية خلال العصر الحالي، وهم الذين يستضيفون بينهم حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري، عايشوا مآسيهم وقصص أفراد عائلاتهم وأقاربهم بين الموت والمعتقلات والتعذيب والاختفاء القسري. لذلك فمن المفهوم أن تكون ردة فعل الأردني على هذا النحو من التعبير، فالسوري، وعلى مدى عقود طويلة، ظل الشقيق، وارتبط مصيرا الشعبين معا خلال فترة ليست قصيرة من التاريخ، خصوصا خلال الثورة العربية الكبرى، وما تلاها من تشكيل الحكومة العربية في دمشق على يد الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي، في العام 1918، والتي عبرت عن حس عروبي وحدوي، وشكلت حلما عربيا في الوحدة والتحرر من التبعي للأجنبي.
لقد شكلت تلك الحكومة أول محاولة لإقامة دولة عربية موحدة وديمقراطية، مع إصرار العرب على حكم أنفسهم بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية، وهي المثال الذي سماه المفكر القومي ساطع الحصري "الدولة العربية بأتم معاني الكلمة”.
التشابك بين الشعبين؛ الأردني والسوري، لا يمكن حصره، فهناك علاقات دم ومصاهرة وأقارب تمتد عابرة للحدود بين البلدين، لذلك لم يكن مستغربا أن تصدر الهيئات الأممية أكثر من تقرير يؤكد أن الأردن هو البلد الوحيد الذي لم يواجه فيه اللاجئون السوريون أي اعتداءات أو مضايقات أو هجمات عنصرية، بل تم استقبالهم بشكل طبيعي، وإدماجهم في المجتعات المضيفة.
الأردنيون، كذلك، لا يتفهمون، ولا يتسامحون مع سفك الدماء، فهم عاشوا في ظل دولة يحكمها القانون الذي يحترم كينونتهم وإنسانيتهم، ويمنحهم مساحة واسعة من الحريات الاجتماعية وحرية التعبير، ولا توجد لديه تعبيرات طائفية أو إثنية، أو مفاهيم تدرج مصطلح "الأقليات” في خطاباتها، كما لم تمارس عليهم السلطات المذابح ولا القمع أو التهجير القسري، لذلك كانت مشاعرهم صادقة ومنطلقة في التبريك لأشقائهم السوريين بالخلاص من نظام ما تزال جرائمه تتكشف ساعة بعد ساعة.
في المقابل، وفي خضم حالة البهجة التي يعيشها الأردنيون اليوم ابتهاجا بما آل إليه الحدث السوري، لا بد من التفكير معمقا في اليوم التالي لانتصار الثورة، وهو حق مشروع للأردن الذي يطمح إلى استقرار الجارة الشمالية بعد ثلاثة عشر عاما من الصراع والحروب، وبعد تدخلات عسكرية من دول وجهات عديدة، وضعت تهديدات حقيقية على حدودنا، واختلالات في قدرة النظام السوري السابق في بسط نفوذه وسيطرته على حدوده.
اليوم، ينبغي لنا التفكير بجدية حول المعطيات الجديدة لإفرازات الثورة، ومدى قدرتها على بسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الوطني، ومدى التجانس الحقيقي بين الائتلافات التي تنضوي تحت لواء "الثورة”، من أجل وأد إمكانيات الاقتتال الداخلي الذي سيقود إلى حرب أهلية قد تؤدي إلى تقسيم الجارة الشقيقة،وهو أمر لن يصب في مصلحة الأردن، بل سيكون مكافأة مجانية لبعض الأطراف، وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني.
على طاولة صانع القرار الأردني العديد من التوجسات التي ينبغي التعامل مع إمكانية حدوثها. ربما يفكر ببعض الطمأنينة في أن المستقبل سيقود إلى تشكل نظام سوري قوي غير مستلب القرار، ولا تتدخل فيه عواصم أخرى بدعاوى طائفية. وقد يكون مستبشرا بقرب انتهاء حروب الكبتاغون التي أنهكت حرس الحدود الأردني بمتابعة مهربيها. لكن، علينا أن نظل متيقظين لما قد تأتي به الايام، فبالتأكيد نحن لا نحب أن نرى أي تغيير للخريطة السورية، ولا نحب أن نشهد أي عنف لدى الاشقاء الذين أعياهم نصف قرن من القمع والتقتيل والتهجير على يد النظام السابق.
لقد شكلت تلك الحكومة أول محاولة لإقامة دولة عربية موحدة وديمقراطية، مع إصرار العرب على حكم أنفسهم بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية، وهي المثال الذي سماه المفكر القومي ساطع الحصري "الدولة العربية بأتم معاني الكلمة”.
التشابك بين الشعبين؛ الأردني والسوري، لا يمكن حصره، فهناك علاقات دم ومصاهرة وأقارب تمتد عابرة للحدود بين البلدين، لذلك لم يكن مستغربا أن تصدر الهيئات الأممية أكثر من تقرير يؤكد أن الأردن هو البلد الوحيد الذي لم يواجه فيه اللاجئون السوريون أي اعتداءات أو مضايقات أو هجمات عنصرية، بل تم استقبالهم بشكل طبيعي، وإدماجهم في المجتعات المضيفة.
الأردنيون، كذلك، لا يتفهمون، ولا يتسامحون مع سفك الدماء، فهم عاشوا في ظل دولة يحكمها القانون الذي يحترم كينونتهم وإنسانيتهم، ويمنحهم مساحة واسعة من الحريات الاجتماعية وحرية التعبير، ولا توجد لديه تعبيرات طائفية أو إثنية، أو مفاهيم تدرج مصطلح "الأقليات” في خطاباتها، كما لم تمارس عليهم السلطات المذابح ولا القمع أو التهجير القسري، لذلك كانت مشاعرهم صادقة ومنطلقة في التبريك لأشقائهم السوريين بالخلاص من نظام ما تزال جرائمه تتكشف ساعة بعد ساعة.
في المقابل، وفي خضم حالة البهجة التي يعيشها الأردنيون اليوم ابتهاجا بما آل إليه الحدث السوري، لا بد من التفكير معمقا في اليوم التالي لانتصار الثورة، وهو حق مشروع للأردن الذي يطمح إلى استقرار الجارة الشمالية بعد ثلاثة عشر عاما من الصراع والحروب، وبعد تدخلات عسكرية من دول وجهات عديدة، وضعت تهديدات حقيقية على حدودنا، واختلالات في قدرة النظام السوري السابق في بسط نفوذه وسيطرته على حدوده.
اليوم، ينبغي لنا التفكير بجدية حول المعطيات الجديدة لإفرازات الثورة، ومدى قدرتها على بسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الوطني، ومدى التجانس الحقيقي بين الائتلافات التي تنضوي تحت لواء "الثورة”، من أجل وأد إمكانيات الاقتتال الداخلي الذي سيقود إلى حرب أهلية قد تؤدي إلى تقسيم الجارة الشقيقة،وهو أمر لن يصب في مصلحة الأردن، بل سيكون مكافأة مجانية لبعض الأطراف، وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني.
على طاولة صانع القرار الأردني العديد من التوجسات التي ينبغي التعامل مع إمكانية حدوثها. ربما يفكر ببعض الطمأنينة في أن المستقبل سيقود إلى تشكل نظام سوري قوي غير مستلب القرار، ولا تتدخل فيه عواصم أخرى بدعاوى طائفية. وقد يكون مستبشرا بقرب انتهاء حروب الكبتاغون التي أنهكت حرس الحدود الأردني بمتابعة مهربيها. لكن، علينا أن نظل متيقظين لما قد تأتي به الايام، فبالتأكيد نحن لا نحب أن نرى أي تغيير للخريطة السورية، ولا نحب أن نشهد أي عنف لدى الاشقاء الذين أعياهم نصف قرن من القمع والتقتيل والتهجير على يد النظام السابق.